إن القرآن، وإن سلم إعجازه، إلا أنه لا يكشف عن صدق نبوة من جاء به، لان قصص القرآن تخالف قصص كتب العهدين التي ثبت كونها وحيا إلهيا بالتواتر.
الجواب
إن القرآن بمخالفته لكتب العهدين في قصصها الخرافية قد أزال ريب المرتاب في كونه وحيا إلهيا، لخلوه عن الخرافات والاوهام، وعما لا يجوز في حكم العقل نسبته إلى الله تعالى، وإلى أنبيائه، فمخالفة القرآن لكتب العهدين بنفسها دليل على أنه وحي إلهي… وقالوا:
إن القرآن مشتمل على المناقضة فلا يكون وحيا إلهيا، وقد زعموا أن المناقضة وقعت في موردين:
الاول: في قوله تعالى:﴿قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا﴾1.
فإنه يناقض قوله تعالى:﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾2.
الجواب
إن لفظ اليوم قد يطلق ويراد منه بياض النهار فقط كما في قوله تعالى:﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾3 .
وقد يطلق ويراد منه بياض النهار مع ليله كما في قوله تعالى:﴿تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ﴾4.
كما أن لفظ الليل قد يطلق ويراد به مدة مغيب الشمس واستتارها تحت الافق، وعليه جاء قوله تعالى:﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾5. ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾6.
وقد يطلق ويراد منه سواد الليل مع نهاره، وعليه جاء قوله تعالى:﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾7.
واستعمال لفظي الليل والنهار في هذين المعنيين كثير جدا، وقد استعملا في الايتين الكريمتين على المعنى الثاني “مجموع بياض النهار وسواد النهار” فلا مناقضة. وتوهم المناقضة يبتني على أن لفظي الليل والنهار قد استعملا على المعنى الاول. وما ذكرناه بين لا خفاء فيه، ولكن المتوهم كابر الحقيقة ليحط من كرامةالقرآن بزعمه هذا. وقد غفل أو تغافل عما في إنجيله من التناقض الصريح عند إطلاقه لهاتين الكلمتين!!!.
فقد ذكر في الباب الثاني عشر من إنجيل متى: إخبار المسيح أنه يبقى مدفونا في بطن الارض ثلاثة أيام أو ثلاث ليال. مع أن إنجيل متى بنفسه والاناجيل الثلاثة الاخر قد اتفقت على أن المسيح لم يبق في بطن الارض إلا يسيرا من آخر يوم الجمعة، وليلة السبت ونهاره، وليلة الاحد إلى ما قبل الفجر.
فانظر أخريات الاناجيل، ثم قل لكاتب إنجيل متى، ولكل من يعتقد أنه وحي إلهي: أين تكون ثلاثة أيام وثلاث ليال. ومن الغريب جدا أن يؤمن علماء الغرب ومفكروه بكتب العهدين، وهي مليئة بالخرافات والمناقضات، وألا يؤمنوا بالقرآن، وهو الكتاب المتكفل بهداية البشر، وبسوقهم إلى سعادتهم في الدنيا والاخرة، ولكن التعصب داء عضال، وطلاب الحق قليلون.
الثاني: إن القرآن قد يسند الفعل إلى العبد واختياره. فيقول:﴿فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾8.
والايات بهذا المعنى كثيرة، فيدل على أن العبد مختار في عمله. وقد يسند الاختيار في الافعال إلى الله تعالى. فيقول:﴿مَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ﴾9.
فزعموا أنه يدل على أن العبد مجبور في فعله. وقالوا: هذا تناقض واضح، والتأويل في الآيات خلاف الظاهر، وقول بغير دليل.
الجواب
إن كل أنسان يدرك بفطرته أنه قادر على جملة من الافعال، فيمكنه أن يفعلها وأن يتركها، وهذا الحكم فطري لا يشك فيه أحد إلا أن تعتريه شبهة من خارج. وقد أطبق العقلاء كافة على ذم فاعل القبيح، ومدح فاعل الحسن، وهذا برهان على أن الانسان مختار في فعله، غير مجبور عليه عند إصداره. وكل عاقل يرى أن حركته على الارض عند مشيه عليها تغاير حركته عند سقوطه من شاهق إلى الارض، فيرى أنه مختار في الحركة الاولى، وأنه مجبور على الحركة الثانية.
وكل إنسان عاقل يدرك بفطرته أنه وإن كان مختارا في بعض الافعال حين يصدرها وحين يتركها إلا أن أكثر مبادئ ذلك الفعل خارجة عن دائرة اختياره، فإن من جملة مبادئ صدور الفعل نفس وجود الانسان وحياته، وإدراكه للفعل، وشوقه اليه، وملاءمة ذلك الفعل لقوة من قواه، وقدرته على إيجاده، ومن البين أن هذا النوع من المبادئ خارج عن دائرة اختيار الانسان، وأن موجد هذه الاشياء في الانسان هو موجد الانسان نفسه.
وقد ثبت في محله أن خالق هذه الاشياء في الانسان لم ينعزل عن خلقه بعد الايجاد، وأن بقاء الاشياء واستمرارها في الوجود محتاج إلى المؤثر في كل آن، وليس مثل خالق الاشياء معها كالبناء يقيم الجدار بصنعه، ثم يستغني الجدار عن بانيه، ويستمر وجوده وإن فني صانعه، أو كمثل الكاتب يحتاج اليه الكتاب في حدوثه، ثم يستغني عنه في مرحلة بقائه واستمراره. بل مثل خالق الاشياء معها “ولله المثل الاعلى” كتأثير القوة الكهربائية في الضوء. فإن الضوء لا يوجد إلا حين تمده القوة بتيارها، ولا يزال يفتقر في بقاء وجوده إلى مدد هذه القوة في كل حين، فإذا انفصل سلكه عن مصدر القوة في حين، انعدم الضوء في ذلك الحين كأن لم يكن. وهكذا تستمد الاشياء وجميع الكائنات وجودها من مبدعها الاول في كل وقت من أوقات حدوثها وبقائها، وهي مفتقرة إلى مدده في كل حين، ومتصلة برحمته الواسعة التي وسعت كل شئ. وعلى ذلك ففعل العبد وسط بين الجبر والتفويض، وله حظ من كل منهما. فإن إعمال قدرته في الفعل أو الترك وإن كان باختياره. إلا أن هذه القدرة وسائر المبادئ حين الفعل تفاض من الله، فالفعل مستند إلى العبد من جهة والى الله من جهة اخرى والايات القرآنية المباركة ناظرة إلى هذا المعنى، وأن اختيار العبد في فعله لا يمنع من نفوذ قدرة الله وسلطانه.
ولنذكر مثلاً تقريبياً يتضح به للقارئ حقيقة الامر بين الامرين الذي قالت به الشيعة الامامية، وصرحت به أئمتها، وأشار اليه الكتاب العزيز.
لنفرض إنسانا كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه، وقد استطاع الطبيب أن يوجد فيها حركة إرادية وقتية بواسطة قوة الكهرباء، بحيث أصبح الرجل يستطيع تحريك يده بنفسه متى وصلها لطبيب بسلك الكهرباء، وإذا انفصلت عن مصدر القوة لم يمكنه تحريكها أصلا، فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك للتجربة مثلا، وابتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده، ومباشرة الاعمال بها – والطبيب يمده بالقوة في كل آن – فلا شبهة في أن تحريك الرجل ليده في هذه الحال من الامر بين الامرين، فلا يستند إلى الرجل مستقلا، لانه موقوف على إيصال القوة إلى يده، وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب ولا يستند إلى الطبيب مستقلا، لان التحريك قد أصدره الرجل بإرادته، فالفاعل لم يجبر على فعله لانه مريد، ولم يفوض اليه الفعل بجميع مبادئه، لان المدد من غيره، والافعال الصادرة من الفاعلين المختارين كلها من هذا النوع. فالفعل صادر بمشيئة العبد ولا يشاء العبد شيئا إلا بمشيئة الله. والايات القرآنية كلها تشير إلى هذا الغرض، فهي تبطل الجبر – الذي يقول به أكثر العامة – لانها تثبت الاختيار، وتبطل التفويض المحض – الذي يقول به بعضهم – لانها تسند الفعل إلى الله.
وهذا الذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت عليهم السلام وعلومهم وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واليك بعض ما ورد منهم:
سأل رجل الصادق عليه السلام فقال:
“قلت: أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: لا.
قلت: ففوض اليهم الامر؟ قال: قال: لا. قال:
قلت: فماذا؟ قال: لطف من ربك بين ذلك“10.
وفي رواية اخرى عنه
“لا جبر ولا قدر، ولكن منزلة بينهما“11.
وفي كتب الحديث للامامية جملة من هذه الروايات. وقالوا:
لو كان الاتيان بكتاب ما معجزا “لعجز البشر عن الاتيان بمثله ” لكان كتاب اقليدس وكتاب المجسطي معجزا، وهذا باطل فيكون المقدم باطلا أيضا.
الجواب
أولا: إن الكتابين المذكورين لا يعجز البشر عن الاتيان بمثلهما، ولا يصح فيهما هذا التوهم، كيف وكتب المتأخرين التي وضعت في هذين العلمين أرقى بيانا منهما، وأيسر تحصيلا، وهذه الكتب المتأخرة تفضل عليهما في نواح اخرى، منها وجود اضافات كثيرة لا أثر لها فيهما.
ثانيا: إنا قد ذكرنا للمعجز شروطا، ومن هذه الشروط أن يكون الاتيان به في مقام التحدي. والاستشهاد به على صدق دعوى منصب إلهي. ومنها أن يكون خارجا عن نواميس الطبيعة، وكلا هذين الشرطين مفقود في الكتابين المذكورين. وقالوا:
إن العرب لم تعارض القرآن، لا لكونه معجزا يعجز البشر عن الاتيان بمثله، ولكنهم لم يعارضوه لجهات اخرى لا تعود إلى الاعجاز. أما العرب الذين عاصروا الدعوة، أو تأخروا عنها قليلا، فقد كانت سيطرة المسلمين تمنعهم عن التصدي لذلك، فلم يعارضوا القرآن خوفا على أنفسهم وأموالهم من هؤلاء المسيطرين، ولما انقرضت سلطة الخلفاء الاربعة وآل الامر إلى الامويين الذين لم تقم خلافتهم على محور الدعوة الاسلامية، صار القرآن مأنوسا لجميع الاذهان بسبب رشاقة ألفاظه، ومتانة معانيه، وأصبح من المرتكزات الموروثة خلفاً عن سلف، فانصرفوا عن معارضته لذلك.
الجواب
أولا: إن التحدي بالقرآن، وطلب المعارضة بسورة من مثله، قد كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قبل أن تظهر شوكة الاسلام، وتقوى سلطة المسلمين، ومع ذلك لم يستطع أحد من بلغاء العرب أن يقوم بهذه المعارضة.
ثانيا: إن الخوف في زمان الخلفاء، وسيطرة المسلمين، لم يمنع الكافر من أن يظهر كفره، وإنكاره لدين الاسلام. وقد كان أهل الكتاب يعيشون بين المسلمين في جزيرة العرب وغيرها بأهنأ عيش وأكرم نعمة، وكان لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم. ولا سيما في عصر خلافة أمير المؤمنين – عليه السلام – الذي اعترف بعدله ووفور علمه المسلمون وغيرهم. فلو كان أحد هؤلاء الكتابيين، أو غيرهم قادرا على الاتيان بمثل القرآن، لاظهره في مقام الاحتجاج.
ثالثا: إن الخوف لو سلم وجوده فهو إنما يمنع عن إظهار المعارضة والمجاهرة بها، فما الذي منع الكتابيين، أو غيرهم من معارضته سرا في بيوتهم ومجامعهم؟ ولو ثبتت هذه المعارضة لتحفظ بها الكتابيون ليظهروها بعد زوال الخوف عنهم، كما تحفظوا على قصص العهدين الخرافية، وسائر ما يرتبط بدينهم.
رابعا: إن الكلام – وإن ارتفع مقامه من حيث البلاغة – إلا أن المعهود من الطباع البشرية أنه إذا كرر على الاسماع هبط عن مقامه الاول، ولذلك نرى أن القصيدة البليغة إذا أعيدت على الانسان مرارا ملها، واشمأزت نفسه منها، فإذا سمع قصيدة اخرى فقد يتراءى له في أول نظرة أنها أبلغ من القصيدة الاولى، فإذا كررت الثانية أيضا ظهر الفرق الحقيقي بين القصيدتين. وهذا جار في جميع ما يلتذ به الانسان، ويدرك حسنه من مأكول، وملبوس ومسموع وغيرها. والقرآن لو لم يكن معجزا لكان اللازم أن يجري على هذا المقياس، وينحط في نفوس السامعين عن مقامه الاول، مهما طال به الزمان وطرأ عليه التكرار، وبذلك تسهل معارضته، ولكنا نرى القرآن على كثرة تكراره وترديده، لا يزداد إلا حسنا وبهجة، ولا يثمر إلا عرفانا ويقينا، ولا ينتج إلا إيمانا وتصديقا، فهو في هذه المزية على عكس الكلام المألوف. وإذن فهذا الوجه يؤكد إعجازه لا أنه ينافيه كما يتوهمه هذا الخصم.
خامسا: إن التكرار لو فرض أنه يوجب انس النفوس به، وانصرافها عن معارضته، فهو إنما يتم عند المسلمين الذين يصدقون به، ويستمعون اليه برغبة واشتياق كلما تكررت تلاوته، فلما ذا لم يعارضه غير المسلمين من العرب الفصحاء؟ لتقع هذه المعارضة موقع القبول ولو من غير المسلمين.
*البيان في تفسير القرآن، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، ص84-91.
1- آل عمران:41.
2- مريم:10.
3- الحاقة:7.
4- هود: 65
5- الليل:1.
6- الحاقة:7.
7- البقرة:51.
8- الكهف:29.
9- الإنسان:30
10- الكافي. كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين.
11- نفس المصدر.
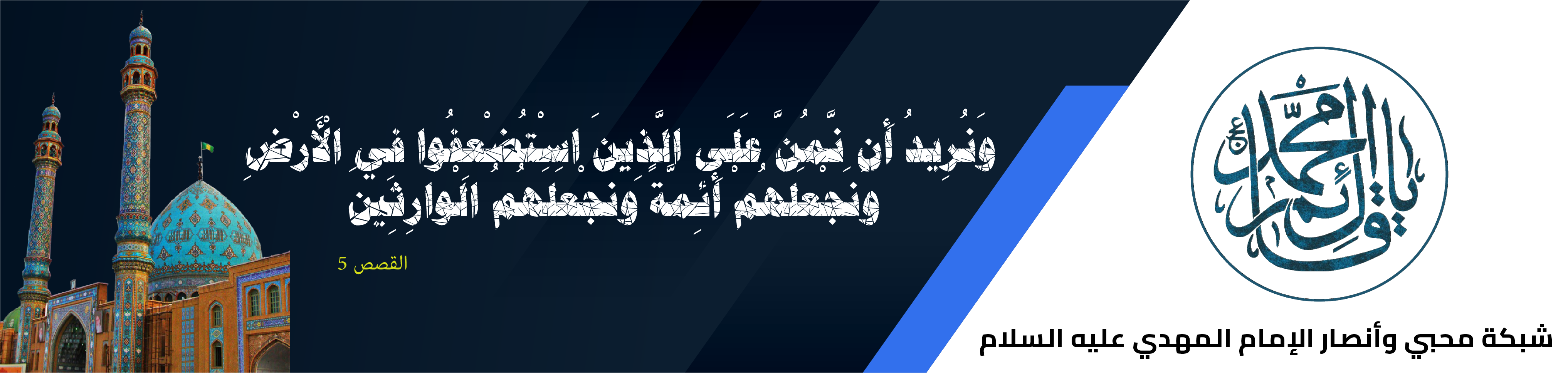 شبكة محبي وأنصار الإمام المهدي ع موقع اسلامي تربوي هادف منذ 1999
شبكة محبي وأنصار الإمام المهدي ع موقع اسلامي تربوي هادف منذ 1999